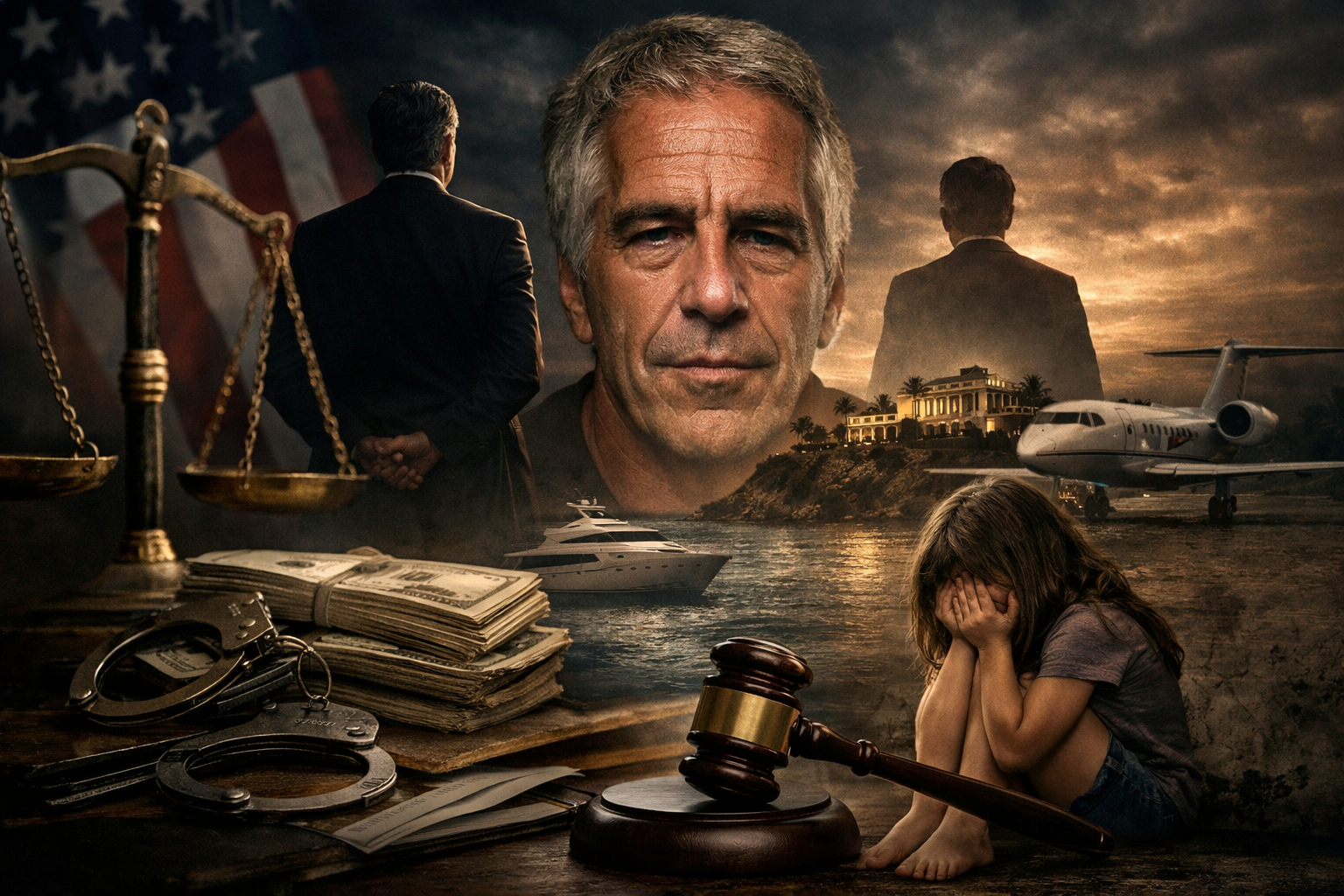د. زياد منصور
باحث في التاريخ الروسي
لماذا سميت الحرب بالحرب الوطنية العظمى؟
تُعد الحرب الوطنية
العظمى
بالروسيةВеликая Отечественная война ، التسمية التي يطلقها الروس وسائر
شعوب الاتحاد السوفييتي السابق على المرحلة التي خاضوا فيها غمار الحرب العالمية
الثانية ضد ألمانيا النازية وحلفائها، ابتداءً من ٢٢ حزيران ١٩٤١ حتى ٩ أيار ١٩٤٥.
وهي تُجسّد أعمق المعاني الوطنية في الوعي الروسي، حيث ارتبطت بالدفاع المصيري عن
الأرض والشعب والكرامة في وجه غزو دموي شامل.
بدأت هذه الحرب مع
انطلاق عملية بارباروسا، حين اجتاحت القوات النازية بقيادة أدولف هتلر أراضي
الاتحاد السوفييتي، في خرق صريح لمعاهدة عدم الاعتداء الموقعة بين الطرفين سنة
١٩٣٩. وقد عبّأ هذا الغزو الغاشم الشعب السوفييتي بكل قوميّاته، فهبّ للدفاع عن
الوطن في حرب شاملة لا هوادة فيها، قادها الحزب الشيوعي والجيش الأحمر، وتداخل
فيها البعد العسكري مع العمق الشعبي والإيديولوجي.
استُخدم مصطلح
"الحرب الوطنية" لأول مرة في روسيا خلال حرب سنة ١٨١٢ ضد نابليون،
للدلالة على الصراع المصيري في وجه محتل أجنبي. وعندما تكرر المشهد عام ١٩٤١،
استُعيد هذا المصطلح مضافًا إليه صفة "العظمى"، للدلالة على ضخامة
المواجهة وشمولها الوطني.
تميّزت الحرب الوطنية
العظمى بعدد من المحطات الفاصلة، أبرزها:
حصار لينينغراد (٨
أيلول ١٩٤١ – ٢٧ كانون الثاني ١٩٤٤): استمر الحصار النازي للمدينة ٨٧٢ يومًا،
وقُتل خلاله أكثر من ٦٤٠ ألف شخص بسبب الجوع والبرد والقصف، غير أن المدينة لم
تستسلم أبدًا.
معركة ستالينغراد (١٧ تموز ١٩٤٢ – ٢ شباط ١٩٤٣): وهي واحدة من أكثر المعارك
دموية في تاريخ البشرية، حيث دارت رحاها على مدى ٢٠٠ يوم، وانتهت باستسلام الجيش
الألماني السادس بقيادة الجنرال باولوس. كانت نقطة تحوّل حاسمة في مجرى الحرب.
معركة كورسك (٥ تموز– ٢٣ آب ١٩٤٣): شهدت أكبر مواجهة دبابات في التاريخ،
خاصة عند قرية بروخوروفكا، وأسفرت عن تدمير جزء كبير من القدرة الهجومية
الألمانية، ومهدت لانتقال المبادرة الاستراتيجية إلى الجانب السوفييتي.
تميّزت هذه الحرب بتضحيات بشرية جسيمة، حيث تجاوزت خسائر الاتحاد السوفييتي
٢٧ مليون شخص، بين عسكريين ومدنيين، وهي الكلفة البشرية الأعلى لأي طرف في الحرب
العالمية الثانية. وقد تُوجت هذه التضحيات بـ تحرير الأراضي السوفييتية، ثم التقدم
إلى أوروبا الشرقية، وصولًا إلى اقتحام برلين في نيسان ١٩٤٥، ورفع العلم السوفييتي
فوق مبنى الرايخستاغ.
انتهت الحرب الوطنية العظمى رسميًا في ٩ أيار ١٩٤٥ بإعلان الاستسلام غير
المشروط لألمانيا النازية، وهو التاريخ الذي يُحتفل به سنويًا في روسيا والدول
الأخرى المنبثقة عن الاتحاد السوفييتي باعتباره عيد النصر.
لقد شكّلت هذه الحرب
لحظة تكوين وطني في التاريخ الروسي، وارتبطت في الوجدان الجمعي بالبطولة والصمود
والمعاناة. ولا تزال ذكراها حية حتى اليوم، عبر النصب التذكارية، والأدب،
والسينما، والمراسم الرسمية، والتقاليد الشعبية، وهي تمثل رمزًا خالدًا لوحدة
الشعب السوفييتي في مواجهة الفاشية.
رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي كان يعيشها الاتحاد
السوفييتي في أربعينيات القرن العشرين، خاصة بعد سنوات من التصنيع القسري،
والمجاعات، وما روي عن قمع سياسي (كان الوطن في وعي السوفييت يعني: الأرض،
العائلة، التراث، اللغة، لا القائد وحده). لذلك، حتى من عانوا من الظلم شعروا أن
الحرب تهدد وجود الوطن بأكمله، وليس فقط النظام، فاختاروا القتال دفاعًا عن وطنهم.
كان الغزو النازي أكثر همجية، لا سيما في مناطق أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا
الغربية، حيث مارست القوات النازية الإعدامات الجماعية، والإبادة بحق الشيوعيين،
والسلاف ، وتم حرق القرى بأكملها (، فغقط في بيلاروسيا تم إبادة أكثر من 3 ملايين
مدني وأسير حرب؛ تم الدفع بأكثر من 380 ألف شخص إلى العبودية في ألمانيا، ومات
الكثير منهم نتيجة لظروف العمل القاسية والتعذيب؛ تم تدمير 209 مدينة، بما في ذلك
مينسك، وغوميل، وفيتيبسك، وبولوتسك، وأورشا، وبوريسوف، وسلوتسك؛ تم حرق ما لا يقل عن 11726 قرية؛ 270 قرية،
أحرقت مع سكانها، شاركت في المصير المأساوي في بلدة قاطين).
لقد زرع هذا في نفوس السكان شعورًا بأن الهزيمة ليست خيارًا، وأن النَّازيين
لن يأتوا كمحرّرين بل كغزاة دمويين. تلك الظروف لم تمنع الشعب بأطيافه وفئاته
وقومياته وأثنياته من خوض حرب ضروس ضد النازية، بل إن تلك المعاناة تحوّلت إلى أحد
أسباب الصمود والمواجهة. ويمكن فهم ذلك من خلال العوامل التالية:
أ- الطابع الوجودي للحرب:
لم تكن الحرب ضد ألمانيا النازية مجرد نزاع عسكري، بل كانت صراعًا وجوديًا
بين مشروعين متناقضين: المشروع النازي القائم على الإبادة والاستعباد، والمشروع
السوفييتي القائم – نظريًا – على بناء مجتمع اشتراكي موحد. هتلر أعلن صراحة في
كتابه كفاحي عن نية الاستيلاء على "الفضاء الحيوي" في الشرق، والقضاء
على "البلاشفة". لذا، كان الشعب السوفييتي يرى أن الهزيمة تعني الدمار الكامل.
ب- التعبئة الأيديولوجية والوطنية:
نجح النظام السوفييتي، عبر وسائل الإعلام، والتعليم، والدعاية الحزبية، في
تعبئة الشعب نفسيًا وسياسيًا. كما أعاد توظيف الرموز الوطنية والتاريخية (مثل
الإشارة إلى "الحرب الوطنية" ضد نابليون) ليجمع بين الشعور القومي والالتزام
الشيوعي، ما خلق وحدة نفسية نادرة بين النظام والشعب.
جـ - الروح الجماعية
والتجربة السوفييتية:
عانى الشعب السوفييتي من سنوات القمع الستاليني، والمجاعة، والتصنيع
القسري، إلَّا أنه خرج من تلك التجارب بجهاز دولة صارم، ونظام تعبئة جماهيرية عالي
الكفاءة. تعوّد الناس على الصبر، والانضباط، والعمل الجماعي، ما شكّل قوة نفسية
وتنظيمية في وجه الغزو النازي.
د- قيادة مركزية صارمة:
على الرغم مما قيل عن قسوة الحكم الستاليني، فقد أظهر ستالين في الحرب
قدرًا من المرونة والتعلم، وتحوّل من حالة الشك والخوف (في البداية) إلى قيادة
حازمة قادرة على إدارة الحرب، بتفويض القيادات العسكرية الكفؤة مثل جوكوف،
وتيموشينكو، وتشويكوف. هذه القيادة المركزية الصارمة سمحت بتوجيه الموارد المحدودة
بفعالية قصوى.
هـ الدعم الشعبي رغم
الجوع:
عانى الناس من الجوع والبرد مسبقًا، ولكن عندما اقترن ذلك بتهديد مباشر
لحياتهم وأرضهم، فإنهم قبلوا التضحيات. في لينينغراد، مثلاً، ظل السكان محاصَرين
٨٧٢ يومًا وسط الجوع والثلوج، لكنهم لم يستسلموا. كانت الكرامة الوطنية والذكريات
الجماعية دافعًا للبقاء والصمود.
و- الإنتاج الحربي والنقل الصناعي:
رغم التراجع في الإنتاج المدني، فإن الاتحاد السوفييتي نجح في نقل مئات
المصانع من المناطق الغربية المهددة إلى ما وراء الأورال، وأعاد تشغيلها بسرعة
لتزويد الجبهة بالأسلحة والذخيرة. رغم تأخر مساعدات الحلفاء حتى أواخر عام 1943
إثر التحول الكبير في مسار الحرب، والذي فرضته معركة كورسك. بحيث اقتصرت المساعدات
على تغطية بعض النقص في الغذاء والمعدات
لم تمنع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الاتحاد
السوفييتي من خوض الحرب، لأن التهديد كان وجوديًا، والقيادة فعّالة، والشعب تعبوي
ومعتاد على التضحيات. بل إن تلك الظروف القاسية شكّلت "بروفة قاسية"
جعلت المجتمع السوفييتي أكثر استعدادًا لتحمل أهوال الحرب الطويلة ضد النازية.
واحدة من أعقد تحديات الاتحاد السوفييتي في بداية الحرب، كانت الضعف النسبي
في التصنيع العسكري المتطور مقارنةً بألمانيا النازية. لكن الاتحاد السوفييتي
تمكّن خلال فترة قصيرة من تحقيق قفزة هائلة في مجال الإنتاج الحربي، ونجح في تحويل
هذا الضعف إلى مصدر قوة. لقد اتخذت خطوات نوعين من بينها:
أوَّلاً: نقل المصانع إلى الشرق. فمع اجتياح القوات الألمانية لأراضي
الاتحاد السوفييتي في صيف سنة ١٩٤١، قرر ستالين تنفيذ واحدة من أكبر عمليات النقل
الصناعي في التاريخ. تم تفكيك أكثر من ١٥٠٠ مصنع ونقلها عبر السكك الحديدية إلى
مناطق آمنة في سيبيريا وآسيا الوسطى وجبال الأورال، حيث أعيد تركيبها وتشغيلها
بسرعة مذهلة، بعيدًا عن خطر القصف الألماني.
هذا الإجراء سمح للاتحاد السوفييتي بمواصلة إنتاج الأسلحة رغم احتلال
مساحات شاسعة من أراضيه.
الخطوة الثانية: تمثلت بإعادة تنظيم الاقتصاد نحو "اقتصاد
الحرب". إذ تم تحويل الاقتصاد السوفييتي بالكامل إلى اقتصاد موجَّه عسكريًا،
بحيث تم إيقاف إنتاج السلع المدنية وتحويل الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية
نحو التصنيع الحربي، خاصة: الدبابات مثل T-34 التي أصبحت رمزًا للجيش الأحمر، فقد تمّ انتاج ٣٥ ألف دبابة. بالنسبة للطائرات مثل
"ياك" Yak و"إيل-2، " IL-2)،
تم انتاج ٤٥ ألف طائرة)، بالنسبة للأسلحة الخفيفة (مثل بندقية "موسين"
ورشاش "بي بي شا")، والتي صممها سيرغي إيفانوفيتش موسين (تم انتاج ٤٠
مليون بندقية) من هذا النوع.
أصبحت المصانع تعمل على مدار الساعة، بثلاث نوبات متتالية، وكان العاملون
يعيشون داخلها أحيانًا. تم إنشاء هيئة التخطيط العسكرية لتنسيق احتياجات الإمدادات
العسكرية، مما أتاح تسريع الإنتاج.
الخطوة الثالثة: تعبئة
النِّساء والشباب، وتحويل جهودهم من أجل الإنتاج الحربي، وتأهيل الجبهة الخلفية
وحفر الخنادق. بسبب انخراط الرجال في الجبهات، لجأ الاتحاد السوفييتي إلى تجنيد
النساء واليافعين للعمل في المصانع، وقد لعبوا دورًا أساسيًا في استمرار عملية الإنتاج.
كثير من الفتيات كن يعملن في تصنيع الذخائر، وقطع الطائرات، وحتى في تركيب
الدبابات.
الخطوة الرابعة: التركيز على الإنتاج الكمي والبساطة
التقنية. لقد تميّزت الصناعة السوفييتية بتركيزها على الأسلحة السهلة التصنيع
والصِّيانة، بخلاف ألمانيا التي ركزت على الأسلحة عالية التقنية.
وهكذا تمكّن السوفييت
من إنتاج آلاف الدبابات والطائرات بأعداد تفوق قدرة ألمانيا على التعويض.
هذا التحول الصناعي والجماهيري كان أحد العوامل الحاسمة
في تحقيق النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.
معركة موسكو
بدأت المعركة في الثلاثين من أيلول سنة ألف وتسعمائة وواحد وأربعين (1941)،
واستمرَّت إلى العشرين من نيسان سنة ألف وتسعمائة واثنين وأربعين (1942)
كانت معركة موسكو، التي بدأت في شهر أيلول من عام ألف وتسعمائة وواحد
وأربعين (1941)، من أكثر المعارك دموية خلال فترة الحرب الوطنية العظمى. فخلال
ثلاثة أشهر فقط، تمكنت قوات ألمانيا الهتلرية من التقدم حتى مشارف العاصمة، تاركةً
خلفها مدنًا وقرى محترقة، وملايين القتلى والأسرى.
حملت العملية العسكرية الهادفة إلى احتلال المدينة اسم «الإعصار» (بالروسية Тайфун – Typhoon)، وفي شهر تشرين الأول من
العام نفسه، فُرض على موسكو نظام الحصار العسكري. وهبّ الشعب بأسره للدفاع عن
الوطن؛ فقد ضحّى الجنود بأرواحهم على جبهات القتال، وهاجمت وحدات الأنصار العدو في
المناطق المحتلة، بينما عمل المدنيون في المؤخرة ليلًا ونهارًا مجسّدين الشعار:
«كل شيء من أجل الجبهة، كل شيء من أجل النصر!
كانت معركة موسكو في أوجها، وكانت ألمانيا تخطط لاحتلال العاصمة بحلول
السابع من تشرين الثاني. وقد دافع عن المدينة ثلاثة جيوش رئيسية (جبهات)، غير أن
القوات الألمانية كانت تفوقها عددًا وعدّة. اقتربت القوات الألمانية من موسكو حتى
مسافة ثلاثين كيلومترًا فقط. وكان هتلر يضغط على جنرالاته للإسراع باجتياح المدينة.
في كانون الأوَّل، بدأت ملامح التحوّل في مجريات المعركة. إذ انتقلت القوات
الروسية إلى الهجوم، وبدعم من سلاح الجو، نجحت في دفع الألمان للتراجع عن المدينة
لمسافاتٍ محدودة. وبدأت القوات الألمانية بالانسحاب، تاركة وراءها الكثير من
معداتها العسكرية.
في معركة موسكو، تمكن الجنود الروس من تدمير مجموعة كبيرة من قوات العدو
تُعرف بـ«مجموعة الجيوش الوسطى» وأجبروا العدو على التراجع مئات الكيلومترات
بعيدًا عن العاصمة. ولم تكن هذه الانتصارات ذات بُعد عسكري فحسب، بل كان لها أيضًا
أثر نفسي كبير، إذ سقطت أسطورة «الآلة العسكرية الألمانية التي لا تُقهَر». وقد
تكبّدت القوات الألمانية خسائر فادحة عند أبواب موسكو لم تتمكن من التعافي منها
لاحقًا.