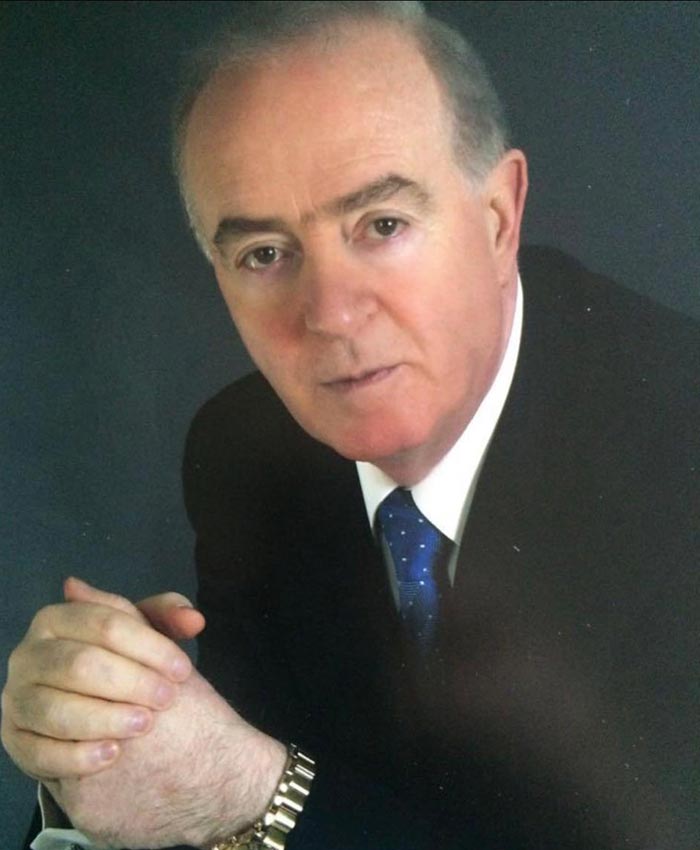خاص ـ "إيست نيوز"
عصام شلهوب
لم ينهَر لبنان في خريف 2019 فجأة، ولم يكن ما جرى زلزالًا ماليًا بلا إنذار. على العكس، كان الانهيار تتويجًا لمسار طويل من السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة، التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية. سياسات قامت على الاستدانة المفرطة، والإنفاق غير المنتج، وتأجيل الإصلاحات، وشراء الوقت بالديون، إلى أن نفد الوقت وانكشفت الدولة على حقيقتها: دولة عاجزة عن السداد، ومترددة في تحمّل المسؤولية.
من يتتبّع بالأرقام والوثائق مسار الدين العام اللبناني، ويحلّل كيف أُنفقت الأموال، وكيف حاولت الدولة لاحقًا التملّص من موجباتها القانونية والأخلاقية،يعرف لماذا تُرك المجتمع اللبناني ليدفع الثمن الأكبر.
مع مطلع التسعينيات، دخل لبنان مرحلة إعادة الإعمار وهو يحمل آمال النهوض بعد حرب مدمّرة. لكن خيار التمويل لم يكن قائمًا على بناء اقتصاد منتج، بل على الاستدانة السريعة. في عام 1993، كان الدين العام اللبناني لا يتجاوز بضع مئات ملايين الدولارات. بعد أقل من ثلاثة عقود، تحوّل إلى واحد من أعلى الديون في العالم قياسًا بحجم الاقتصاد.
تشير بيانات وزارة المالية وتقارير مؤسسات دولية إلى أن الدين العام تجاوز 40 مليار دولار قبل الانهيار، فيما أدّى انهيار سعر الصرف وتراجع الناتج المحلي إلى تضخيم النسبة الفعلية للدين إلى أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي. لم يكن هذا التضخم نتيجة حرب جديدة أو كارثة طبيعية، بل نتيجة قرار سياسي مزمن بالإنفاق عبر الاقتراض بدل الإصلاح.
اللافت أن كل الحكومات المتعاقبة، على اختلاف تركيباتها السياسية، التقت على النهج نفسه: تأجيل الحلول البنيوية، وتغطية العجز عبر المزيد من الدين.
لكن في أي تحقيق مالي، يبقى السؤال الأهم: أين ذهبت الأموال؟
ان تفكيك بنية الإنفاق العام في لبنان يكشف حقيقة صادمة: الجزء الأكبر من الأموال المقترضة لم يُوجَّه إلى استثمارات منتجة، بل إلى إنفاق جارٍ لا يولّد نموًا ولا فرص عمل مستدامة.
أولًا، شكّلت خدمة الدين العام عبئًا متزايدًا. لسنوات طويلة، استحوذت فوائد الدين وحدها على نسبة مرتفعة من الموازنة، ما جعل الدولة تقترض لتسديد فوائد ديون سابقة، في حلقة مفرغة كرّست العجز بدل معالجته.
ثانيًا، توسّع القطاع العام بشكل غير مدروس. ارتفعت كتلة الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية من دون إصلاح إداري حقيقي أو تحسين في الإنتاجية، فتحوّل القطاع العام إلى عبء مالي بدل أن يكون رافعة للخدمات.
ثالثًا، استنزفت المؤسسات العامة الخاسرة، وفي مقدّمها مؤسسة كهرباء لبنان، عشرات مليارات الدولارات من الخزينة. ورغم هذا الإنفاق الهائل، بقيت الخدمة متعثّرة، ما شكّل نموذجًا صارخًا للهدر المزمن.
في المقابل، ظلّ الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والإنتاج والصناعة والزراعة محدودًا، وغير كافٍ لبناء اقتصاد قادر على تحمّل عبء الدين. ولا يمكن فهم الانهيار المالي بمعزل عن العلاقة العضوية بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان. فقد موّلت الدولة عجزها عبر الاقتراض من المصارف المحلية، التي بدورها أعادت توظيف أموالها لدى مصرف لبنان، مقابل فوائد مرتفعة.
هذا النموذج خلق نظامًا ماليًا قائمًا على تدوير الديون بدل تمويل الاقتصاد الحقيقي. ومع تفاقم العجز، لجأت الدولة عمليًا إلى استخدام احتياطات مصرف لبنان لتمويل إنفاقها، ما يعني استخدام أموال المودعين بشكل غير مباشر.
التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أكّد وجود خسائر ضخمة ناتجة عن هذا النموذج، وكشف كيف جرى استنزاف الموارد النقدية لتغطية عجز الدولة، بدل ضبط الإنفاق أو إعادة هيكلة الدين في وقت مبكر. وعندما توقّفت الدولة عن سداد ديونها في عام 2020، كان يُفترض أن تتحمّل المسؤولية الأساسية بوصفها الجهة التي استدانت وأنفقت. لكن ما حصل كان معاكسًا تمامًا.
فبدل الاعتراف بالخسائر وتحميلها للدولة ومصرف لبنان وفق تسلسل واضح للمسؤوليات، طُرحت خطط وقوانين تسعى إلى توزيع الخسائر على المودعين والقطاع المصرفي، مع تحييد الدولة قدر الإمكان.
مشاريع قوانين مثل «الانتظام المالي» و«إعادة هيكلة المصارف» أثارت انتقادات واسعة، لأنها، بحسب خبراء، تعفي الدولة من الجزء الأكبر من المسؤولية، رغم أن الدولة كانت المستفيد الأول من الاستدانة.
هذا التوجّه عكس محاولة واضحة لإعادة كتابة رواية الانهيار: تحميل المصارف والمودعين الكلفة، وتقديم الدولة كضحية لا كفاعل أساسي. وهو ما يثبت أن التنصّل من المسؤولية لم يكن تفصيلًا تقنيًا، بل خيارًا سياسيًا. ويمكن تلخيص أسبابه بثلاثة عوامل مترابطة:
أولًا، غياب المحاسبة السياسية. لم يُحاسَب أي مسؤول عن السياسات المالية التي راكمت الدين، ما شجّع على الاستمرار في النهج نفسه.
ثانيًا، تشابك المصالح بين السلطة السياسية والمالية والمصرفية، ما يجعل تحميل الدولة للخسائر تهديدًا مباشرًا لبنية النظام القائم.
ثالثًا، الخوف من التداعيات القانونية. الاعتراف الكامل بمسؤولية الدولة يفتح الباب أمام مطالبات داخلية وخارجية، ويكرّس صورة الإفلاس السيادي.
وبينما تتنازع الدولة والمصارف على توزيع الخسائر، دفع المجتمع اللبناني الثمن الأكبر. تبخّرت الودائع، انهارت العملة، تراجعت القدرة الشرائية، وانهارت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وكهرباء. والأخطر أن هذا الانهيار ترافق مع غياب أي رؤية تعافٍ شاملة، ما جعل الأزمة تتحوّل من صدمة مالية إلى أزمة اجتماعية عميقة تهدّد بنية المجتمع نفسه.
لا يواجه لبنان أزمة تقنية أو محاسبية فحسب، بل أزمة مسؤولية سياسية وأخلاقية. دولة استدانت لعقود، أنفقت بلا رؤية إنتاجية، ثم انهارت، فاختارت التنصّل بدل الاعتراف والمحاسبة.
من دون مواجهة صريحة لهذا المسار، وتحميل الدولة الدور الأساسي في الخسائر، لن يكون أي إصلاح ممكنًا، ولن تُستعاد الثقة، داخليًا أو خارجيًا. فالاقتصادات لا تنهض بالإنكار، بل بالاعتراف، ولا تتعافى بالهروب من المسؤولية، بل بتحمّلها.